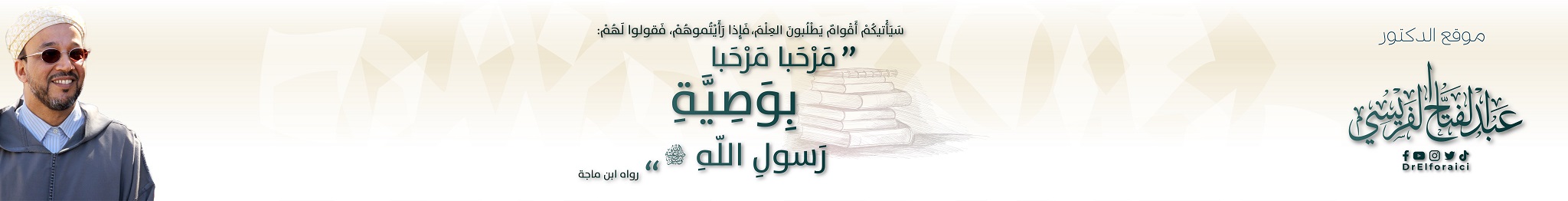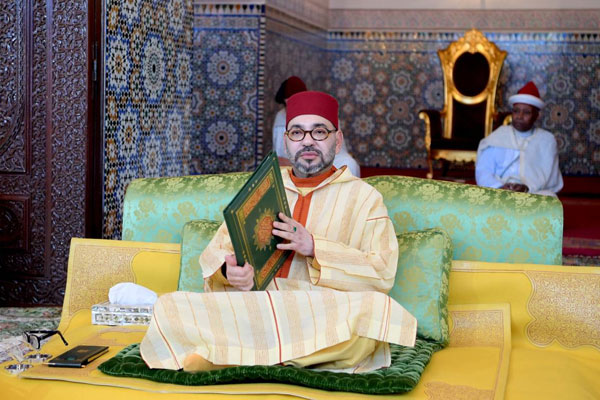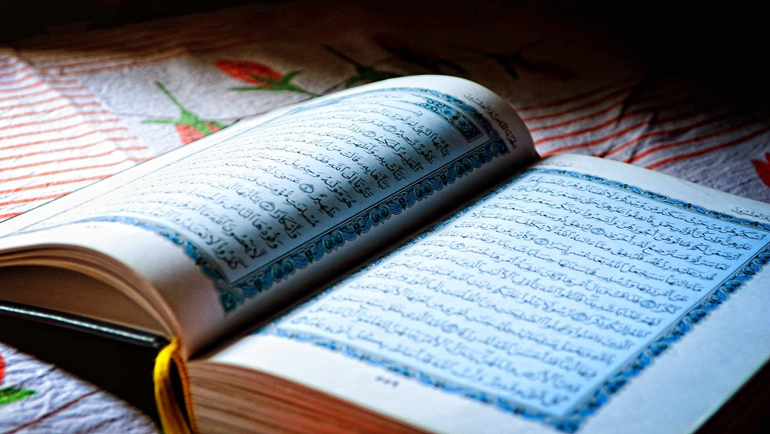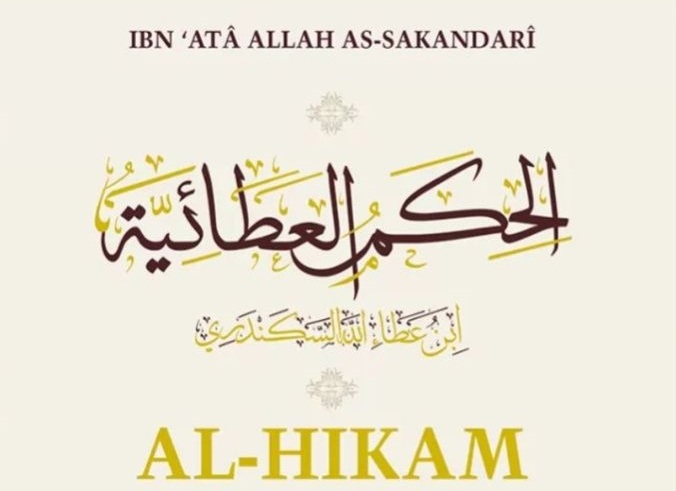خَلَق اللَّهُ سبحانه الخَلْقَ، وأمرهم بعبادتِه، وبَعَث إليهم رُسُلَه رحمةً بهم، وأنزل مع كلِّ واحدٍ منهم كتاباً لكمال الحُجَّة والبيان، قال سبحانه: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾، وخَصَّ سبحانه القرآنَ الكريمَ من بين سائرِ الكتب بالتَّفضيل، جُمِعت فيه محاسنُ ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فكان شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلِّها، فكلُّ كتابٍ يشهد القرآنُ بصِدْقِه فهو كتابُ اللَّه، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾.
لم يُنزَّل من السَّماء كتابٌ أهدى منه، وهو أحسنُ الأحاديثِ المُنَزَّلة من عند اللَّه ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثَانِيَ﴾، وقد مَنَّ اللَّهُ على رسولِه به فقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾، وجعله شرفاً له ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾، قال شيخ الإسلام رحمه الله: «أَعْظَمُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابُ اللَّهِ»، وهو شَرَفٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ وعَمِلَ به من هذه الأُمَّة، قال عز وجل: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾.
وَصَفه اللَّهُ بأنَّه مجيدٌ وكريمٌ وعزيزٌ، وتحَدَّى الخَلْقَ بأن يأتوا بمِثْلِه، أو بمِثْلِ عَشْرِ سُوَرٍ منه، أو بمِثْلِ سورةٍ منه؛ فصاحتُه وبلاغتُه ونَظْمُه وأسلوبُه أمرٌ عجيبٌ بديعٌ خارقٌ للعادة، أعجزت الفُصَحاءَ والبُلَغاءَ معارضَتُه، فإنَّه ليس من جنس الشِّعر ولا الرَّجَز، ولا الخَطابة ولا الرَّسائل، ولا نَظْمُه نَظْمُ شيءٍ من كلام النَّاس عَرَبِهم وعَجَمِهم، آياتُه جَمَعت بين الجَزالة والسَّلاسة، والقوَّة والعُذوبة، سَمِعَه فُصَحاء العرب وبُلغاؤهم وأربابُ البيان فيهم فأقرُّوا بتفرُّدِه، قال الوليد بن المُغِيرة – وهو من سادات الكفَّار البُلغاء -: «وَاللَّهِ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمُ بِالأَشْعَارِ مِنِّي، وَلَا أَعْلَمُ بَرَجَزٍ وَلَا بِقَصِيدَةٍ مِنِّي، وَلَا بِأَشْعَارِ الجِنِّ، وَاللَّهِ مَا يُشْبِهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئاً مِنْ هَذَا».
ومع إعجازه سَهَّل اللَّهُ على الخَلْقِ تلاوتَه، ويَسَّر معناه؛ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾، قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ يَسَّرَهُ عَلَى لِسَانِ الآدَمِيِّينَ، مَا اسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامِ اللَّهِ».
والإعجازُ في معناه أعظمُ وأكثرُ من الإعجازِ في لَفْظِه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: «جَمِيعُ عُقَلَاءِ الأُمَمِ عَاجِزُونَ عَنِ الإِتْيَانِ بِمِثْلِ مَعَانِيهِ، أَعْظَمَ مِنْ عَجْزِ العَرَبِ عَنِ الإِتْيَانِ بِمِثْلِ لَفْظِهِ».
القرآنُ قولٌ فَصْلٌ مُشتَمِلٌ على قواعد الدِّين والدُّنيا والآخرة، فيه العقائدُ، والأحكامُ والتَّشريعاتُ، والأخلاقُ والقَصَصُ، والأخبارُ والمواعظُ، وأُسُسُ السَّعادة والفلاحِ، قال عنه سبحانه: ﴿هَذَا هُدىً﴾.
آياتُه مُحْكَمةُ الألفاظ مُفَصَّلةُ المعاني، فآيةٌ واحدةٌ فيه بيَّنت الحكمةَ من خَلْقِ الثَّقلَيْن؛ ﴿وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، وجزءٌ من آيةٍ أَصَّلت الدِّين؛ ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾، وثلاثُ كلماتٍ مَنِ استجاب لها سَعِد في الدُّنيا والآخرة؛ ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾، قال ابن القيِّم رحمه الله: «لَيْسَ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ مُتَضَمِّنٌ لِلْبَرَاهِينِ وَالآيَاتِ عَلَى المَطَالِبِ العَالِيَةِ مِثْلَ القُرْآنِ».
لا تَفْنى عجائبُه، ولا يُحاط بمعجزاتِه ممَّا في آياتِه وسُوَرِه، فآيةُ الكرسيِّ أَفْضَلُ آيةٍ في كتابِ اللَّهِ تَحْفَظُ العبدَ، و«لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ» (رواه البخاري)، و«مَنْ قَرَأَهَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ» (رواه النسائي)، و«مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ – أَيْ: مِنَ الشَّرِّ -» (متفق عليه)، وثلاثُ آياتٍ إذا قالها العبدُ قال اللَّهُ: «حَمَدَنِي عَبْدِي، وَأَثْنَى عَلَيَّ، ومَجَّدَني؛ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾» (رواه مسلم)، و«مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ» (رواه مسلم).
وسورةُ الفاتحة أعظمُ سورةٍ فيه (رواه البخاري)، قال شيخ الإسلام رحمه الله: «تَأَمَّلْتُ أَنْفَعَ الدُّعَاءِ فَإِذَا هُوَ سُؤَالُ العَوْنِ عَلَى مَرْضَاتِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي الفَاتِحَةِ فِي ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾»، وسورتان قصيرتان أُنْزِلت لَيْلاً لم يُرَ مثلُهنَّ قطُّ – أي: في التَّعويذ من شَرِّ الأشرار -؛ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (رواه مسلم).
وآياتُه شفاءٌ من الأسقام، قال أبو سعيد الخدريُّ رضي الله عنه: «نَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ لُدِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَبَرَأَ» (متفق عليه)، قال ابن القيِّم رحمه الله: «كُنْتُ أُعَالِجُ نَفْسِي بِالفَاتِحَةِ، فَأَرَى لَهَا تَأْثِيراً عَجِيباً، فَكُنْتُ أَصِفُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْتَكِي أَلَماً، وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَبْرَأُ سَرِيعاً».
آياتُه أبكت السَّادةَ العظماء؛ كان أبو بكر رضي الله عنه إذا صَلَّى لم يُسْمِعِ النَّاسَ من البكاء، وصَلَّى عمرُ بن الخطَّاب رضي الله عنه مرَّة الصُّبحَ في أصحابِه فسُمِع نَشِيجُه من آخر الصُّفوف وهو يقرأ سورة يوسف: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.
وإذا قَرَع القرآنُ السَّمع سَرَى إلى القلوب فأبكاها خشوعاً، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لابن مسعودٍ رضي الله عنه: «اقْرَأْ عَلَيَّ القُرْآنَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً﴾، رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ» (متفق عليه)، وقرأ جعفرُ بن أبي طالب رضي الله عنه صَدْراً من سورة مريم على النَّجاشيِّ فبَكَى حتى أخضَلَ لِحيَتَه – أي: ابتلَّت -، وبَكَتْ أساقِفَتُه – أي: رؤساء الدِّين منهم – حتى أخضَلُوا مصاحفَهم (رواه أحمد).
القرآنُ المجيدُ يأخذ بالألبابِ، وهو أقوى سبيلٍ للدَّعوة إلى الإسلام، قالت عائشة رضي الله عنها: «ابْتَنَى أَبُو بَكْرٍ قَبْلَ الهِجْرَةِ مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا – أَيْ: يُخْرِجُهُمْ مِنْ دِينِهِمْ إِلَى دِينِهِ -» (رواه البخاري).
وسَمِعَ جُبَيْر بنُ مُطْعِم رضي الله عنه رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطُّور فلمَّا بَلَغ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ﴾ قال: «كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ» (رواه البخاري).
واستمعتِ الجِنُّ للقرآن فآمنوا، واغتبطوا، وقالوا مُتحدِّثين بنعمةِ اللَّه عليهم: ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ﴾.
ولو أنزل اللَّهُ القرآن على جبلٍ لتَذَلَّل وتَصَدَّع من خَشْيةِ اللَّه؛ حَذَراً من أنْ لا يُؤَدِّيَ حَقَّ اللَّهِ عز وجل في تعظيم القُرآنِ، فأَمَرَ اللَّهُ النَّاسَ أنْ يأخذوه بالخَشْيةِ الشَّديدةِ والتَّخشُّعِ.
آياتُه بَدَّلت أحوالَ الصَّحابة رضي الله عنهم؛ لمَّا نزل تحريم الخمر، وسَمِع عمرُ رضي الله عنه قولَه تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ﴾ قَالَ: «انْتَهَيْنَا، انْتَهَيْنَا» (رواه أحمد)، و«هَرَقُوهَا حَتَّى جَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ» (متفق عليه)، وحين نزلت: ﴿لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ﴾ أي: الجَنَّة ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قال أبو طلحة رضي الله عنه: «إِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ» (متفق عليه).
وآيةٌ ثبَّتَت الصَّحابةَ رضي الله عنهم في أشدِّ مصيبةٍ نزلت بهم؛ حين توفِّي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأنكر بعضُهم موتَه لهَوْلِ ما سمعوا؛ تلا أبو بكر رضي الله عنه قولَ اللَّهِ تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ﴾، قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ إِلَّا حِينَ تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَلَمْ تَسْمَعْ بَشَراً إِلَّا يَتْلُوهَا» (رواه البخاري).
ولمَّا نزلت آيةُ السِّتر والعفاف ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ﴾ قالت عائشةُ رضي الله عنها: «يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ، شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ – أَيْ: أَكْسِيَةً لَهُنَّ- فَاخْتَمَرْنَ بِهَا» (رواه البخاري).
آياتُه تزيد في الإيمان ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً﴾، ولمنزلة القرآن عند اللَّه أجرُ تلاوتِه بعدد الحروف؛ بل مضاعفة، قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا» (رواه الترمذي).
ولِمَا في القرآن من الكنوز العظيمة حَرَصَ الصَّحابةُ أن لا يفوتهم شيءٌ منه إذا نَزَل، قال عمرُ رضي الله عنه: «كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ يَنْزِلُ يَوْماً، وَأَنْزِلُ يَوْماً، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ» (رواه البخاري).
وأهلُ الكتاب القائمون بمقتضاه يفرحون بالقرآن لِمَا في كُتُبِهم من الشَّواهد على صِدْقِه والبِشارة به؛ قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾.
كتابٌ مُعجِزٌ جَعَله سبحانه آيةً على صِدْقِ نُبُوَّةِ مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، لا يزول بموته؛ بل باقٍ إلى يوم القيامة، وإذا استمرَّ المُعْجِزُ كَثُرَ الأتباعُ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْياً أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعاً يَوْمَ القِيَامَةِ» (متفق عليه).
وتكفَّل سبحانه بحِفْظِ هذه المعجزة فلا تُحَرَّف ولا تزول، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ في خُطبته: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، وَقَالَ: وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لَا يَغْسِلُهُ المَاءُ» (رواه مسلم)، قال النَّوويُّ رحمه الله: «مَعْنَاهُ مَحْفٌوظٌ فِي الصُّدُورِ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الذَّهَابُ؛ بَلْ يَبْقَى عَلَى مَرِّ الأَزْمَانِ».
وكان الصَّحابة رضي الله عنهم إذا تذكَّروا انقطاعَ الوَحْيِ بعد وفاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَكَوْا، قال أبو بكر لعمرَ رضي الله عنهما: «انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ؛ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا» (رواه مسلم).
ولعُلُوِّ القرآن أعلى اللَّهُ أهلَه إلى المراتب العالية، والمنازل الرَّفيعة، وعَظَّم حُرْمَتَهم، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ القُرَّاء ويَأْتَمِنُهم ويحزن لموتهم، وقَنَتَ على مَنْ قتلهم شهراً، ولم يَقْنُت على أحدٍ زمناً طويلاً إلَّا على مَنِ اعتدى عليهم.
وسار الخلفاء الرَّاشدون على توقير أهلِ القرآن وإجلالِهم ومعرفةِ قَدْرِهم، فكان عمر رضي الله عنه يُدْنِيهم منه ويُقَدِّمهم في مَجْلِسه ويجعلهم أهلَ مَشُورَتِه، قال القرطبيُّ رحمه الله: «تَظَاهَرَتْ الرِّوَايَاتُ بِأَنَّ الأَئِمَّةَ الأَرْبَعَةَ جَمَعُوا القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَأَجْلِ سَبْقِهِمْ إِلَى الإِسْلَامِ وَإِعْظَامِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ».
واللَّهُ لم يُنْزِلْ كتاباً من السَّماء فيما أَنْزَلَ من الكُتُبِ المُتعدِّدةِ على أنبيائِه، أَكْمَلَ ولا أَشْمَلَ ولا أَفْصَحَ ولا أَعْظَمَ ولا أَشْرَفَ من القرآن، وهو من فَضْلِ اللَّه ورحمتِه على العباد، مَنْ فَرِح به وبالإسلام فقد فَرِح بأعظم مفروحٍ به، وهما خَيْرٌ مِمَّا يُجْمَعُ مِنْ حُطَامِ الدُّنيا، وأموالِها وكنوزِها؛ ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾، ومَنْ أحبَّ القرآن فقد أحبَّ اللَّهَ، قال ابن القيِّم رحمه الله: «وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَا عِنْدَكَ وَعِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ، فَانْظُرْ مَحَبَّةَ القُرْآنِ مِنْ قَلْبِكَ، وَالتِذَاذَكَ بِسَمَاعِهِ».
فالسَّعيدُ مَنْ صَرَف هِمَّتَه إلى تعلُّم القرآن وتعليمه، والمُوَفَّقُ مَنْ اصطفاه اللَّه لتعظيمه وتعظيم أهلِه والتَّذكيرِ به.
أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم
﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴾.
وختاما:
فمَنْ أراد الهدايةَ فعليه بالقرآن، ومَنْ أراد الانتفاعَ به فليجمع قَلْبَه عند تلاوتِه وسماعِه، وليستشعر كلامَ اللَّه إليه؛ فإنَّه خطابٌ منه للعبيد على لسان رسولِه، وليس شيءٌ أنفعَ للعبد في معاشِه ومعادِه وأقربَ إلى نجاتِه من تلاوةِ القرآن، ومَنْ تدبَّر القرآنَ طالباً منه الهُدَى تبيَّن له طريقُ الحقِّ.
د. عبد المحسن القاسم